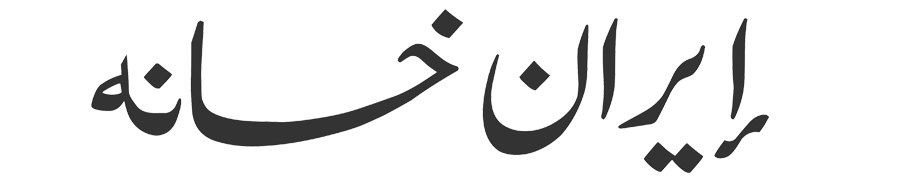فاجأت الاحتجاجات الأخيرة في العديد من المدن والبلدات الإيرانية العالم، وأربكت الحكومة الإيرانية والمؤسسة السياسية الحاكمة. ولكن التوقع بأن تتصاعد الاحتجاجات إلى انتفاضة شعبية وحل ألغاز الجمهورية الإسلامية لم يتحقق. ويمكن للحكام الإيرانيين أن يستأسدوا، لكنهم لا يستطيعون تجنب المناقشات الأوسع حول مستقبل الاقتصاد الإيراني والسياسة الإيرانية التي بدأت الاحتجاجات بسببها.
وكانت هذه عبارة عن احتجاجات اقتصادية. وهي تعكس إحباطا عميقا ومتجذرا بسبب الركود الاقتصادي وسوء الإدارة والفساد وتزايد معدل التفاوت في الدخل مع ظهور واضح للثروة على الصفوة. ونطقت جغرافيتهم بالفجوة المتزايدة التي تفصل المراكز الحضرية الكبيرة، خاصة العاصمة طهران، عن المدن الصغيرة والمناطق الريفية، والتي تتطابق تقريبا مع قاعدة روحاني السياسية و قاعدة منافسيه المحافظين و المتشددين، تباعا. وقد اجتاحت الاحتجاجات العديد من تلك المدن الصغيرة، وحشدت أصواتا غاضبة من بين الساخطين في المجتمع، حيث هؤلاء هم الأكثر ارتباطا برسالة الثورة.
ومن المهم أيضا أن نلاحظ ما الذي لم تكن عليه هذه الاحتجاجات. إنها لم تكن تكرارا لانتفاضية مدنية وثقافية من الماضي للمواطنين الأثرياء الذين يطالبون بالتغيير الاجتماعي والثقافي وحرية التعبير والمشاركة السياسية. وهنا يكمن الخبر السار للجمهورية الإسلامية. إن التهديدات الأخطر التي يتعرض لها النظام كانت تأتي عادة عندما كانت تتصاعد حالة التمرد في طهران، كما حدث في يونيو 2009 للاحتجاج على نتيجة الانتخابات الرئاسية في ذلك العام. وفي تلك المرحلة، شكلت حشود من الطلاب وحشودا كبيرة من المدن الحضرية غير المحلية تهديدا حاليا لقيادة المدينة، مما يعني ضمنا استقرار النظام الحاكم.
يذكر أن العامل المهم في الاحتجاجات الأخيرة، والسبب وراء أنهم لم يشبهوا الكفاح ضد استبداد ترامب الذي حاول تصويره في تغريداته، هو الكلب الذي لم ينبح. ولم تنضم أصوات المعارضة المدنية إلى الدعوة الشعبية إلى العدالة الاقتصادية. لماذا ا؟ أولا، لقد كان الحضريون، كما ذكر الخبير الاقتصادي جواد صالحي أصفهاني، هم المستفيدين الرئيسيين من سياسات الرئيس حسن روحاني المتعلقة بالتحرير الاقتصادي، مثل حديثه عن الاعتدال، وكانوا الداعمين الرئيسيين لسعيه إلى التوصل إلى اتفاق نووي. وكانوا يتوقعون أن يؤدي الاتفاق إلى إنهاء العزلة الدولية الإيرانية، وتحقيق فوائد اقتصادية، وتحسين المناخ السياسى فى الداخل.
جدير بالذكر أنهم رأوا في روحاني سبيلا منظما للتغيير. وكان الكثيرون من بين هؤلاء الحضريين يخشون فعلا من أن تؤدي الاحتجاجات إلى الفوضى، أو أن تميل السياسة الإيرانية لصالح عدوهم، الديماغوجي الشعبي والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وبدون أن تنضم طهران إلى الاحتجاجات، فلن يشكلوا إطلاقا تهديدا وجوديا للجمهورية الإسلامية. ولن يتعرض أي نظام لتهديد حقيقي ما لم يفقد السيطرة على مناطقه الحضرية، وأهمها عاصمته. ولم تكن قوات الأمن الإيرانية منظمة لاحتواء الاحتجاجات في عدد كبير من المدن الصغيرة، ومن ثم تم التقاطهم في صورة غير مهيأة. ومع ذلك، فبدون طهران، كان بإمكان قوات الأمن أن تفكر في الاحتجاجات على أنها حرائق صغيرة قد تحرق نفسها في نهاية المطاف كما يبدو أنها قد فعلت.
جدير بالذكر أنه إن لم تنضم الطبقات الوسطى الحضرية والفقراء إلى قضية مشتركة، كما فعلوا في عام 1979، لن تكون هناك ثورة. وفي حسابات الاستقرار هذه، من الأهمية بمكان إبقاء طهران والمراكز الحضرية الرئيسية سعداء. وليس من قبيل المصادفة أن قائد الحرس الثوري، في أول بيان علني عن الاحتجاجات، قام بربط المحتجين بالرئيس السابق أحمدي نجاد، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق معه بسبب دوره في الاضطرابات.
ولكنها ليست مجرد المخاوف من ثورة يعقوب هي التي أبقت طهران هادئة. بل أيضا وعد روحاني السياسي. لقد فاز روحاني بالانتخابات الرئاسية مرتين، في عامي 2012 و 2015، وفي كلتا الحالتين كان ذلك بسبب شعبيته وسط الطبقات الوسطى في المناطق الحضرية، واستمرار حصوله بثبات على تصويت طهران. وأظهرت الاحتجاجات أنه لا يحظى بشعبية لدى الفقراء، ولكن سكان المدن من الطبقة المتوسطة في طهران لا يتقاسمون نفس الدرجة من حالة عدم الرضا. وإذا كان الاستقرار يعتمد على طهران، إذا فالاحتجاجات لم تؤد سوى إلى تعزيز الموقف السياسي لروحاني.
والواقع أن برنامج روحاني يفضل طهران. لقد قام بخفض الدعم الحكومي مع رفع أسعار الوقود أيضا. وفشل في التصدي للفساد، وعجز عن الوفاء بوعود الرخاء الاقتصادي عقب الاتفاق النووي. وقد نشرت تفاصيل الميزانية للمرة الأولى في ديسمبر، مما أثار ضجة على وسائل الإعلام الاجتماعية. وكان روحاني يأمل في أن تبين الشفافية أن يديه مقيدة، وأنه لم يكن حرا في تحويل التمويل من قوات الأمن والمؤسسات الدينية إلى برامج الاستحقاق. ولكن هذا لم يجنيه غضب المتظاهرين.
وقد تراجعت هذه الخطوة مع انتشار الاحتجاجات بشكل سريع، واكتسبت حدة، وتحولت ضد المؤسسة السياسية ككل. وربما قد تم احتواء المظاهرات في الوقت الراهن، ولكن الجمهورية الإسلامية ستشعر بأنها مضطرة إلى معالجة المظالم الاقتصادية الكامنة التي كشفت عنها الاحتجاجات. إن الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى فتح شق عميق في المعسكر المحافظ، والقلق الأكبر أنه في حالة عودة الاحتجاجات، ففي المرة القادمة يمكن للطبقة المتوسطة الحضرية أن تتفاعل بشكل مختلف.
يذكر أنه لا يوجد أحد من بين حكام إيران حريص على التحول إلى الشعبوية لإسكات الفقراء. وهذا يعني جولة أخرى من السياسة على غرار أسلوب أحمدي نجاد، الأمر الذي سيزيد من عزلة إيران، ويضعف اقتصادها، ويبعد الطبقة المتوسطة الحضرية. وبعد ذلك، كانت إيران قد تاجرت باستقرارا محتملا في المدن الصغيرة بسبب وجود نوع أكثر خطورة من الاضطرابات السياسية الحضرية تشبه النوع الذي شهدته البلاد في حزيران 2009.
والبديل الوحيد هو مواصلة “سياسة روحاني الاقتصادية”، وهي عبارة عن مزيج من تحرير الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة، بما في ذلك الحد من التأثير الاقتصادي لمؤسسات البقرة المقدسة ومؤسسات الدولة والحرس الثوري، والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق الحد من الضغوط الاقتصادية الدولية. والأمل يكمن في أن الاستراتيجية الاقتصادية التي انتصرت على الطبقة المتوسطة الحضرية يمكنها أن تهدأ أيضا بما يكفي الطبقة المتوسطة الدنيا والفقراء لضمان الاستقرار السياسي.
واعترف روحاني في تصريحاته حول الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الأسبوع بالمظالم الاقتصادية التي دعمت الاضطرابات، لكنه أضاف أن الناس لا يريدون أن يملي عليهم أحد أوامر فيما يتعلق بكيفية العيش. وكانت هذه خطوة أولى هامة لتجميع برنامج سياسيي شامل يمكنه أن يجمع بين الفقراء الساخطين وقاعدة الطبقة المتوسطة الحضرية.
ولن تكون هناك تحولات جذرية على وشك الحدوث. وستكون هناك مقاومة للتغيير، ولكن حتما، فالمناقشات الأكبر التي تدول حاليا تتعلق بكيفية تحقيق نمو اقتصادي أكبر. وهذه المناقشات لن تشير إلى مسارا واضحا، ولكن مع حضور الاحتجاجات في ذهن الجميع، ستكون المنفعة لروحاني. إن الاحتجاجات لم تسقط الجمهورية الإسلامية إلا أنها قد تكون أكثر صرامة في المسار الذي شرعت فيه عندما انتخبت روحاني رئيسا في عام 2012.