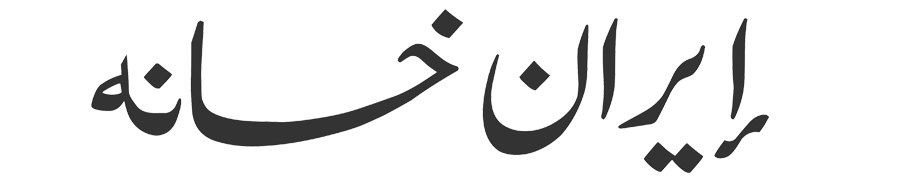تمر السنون، وتُخلِف من ورائها جفاءً يتبدد بمرور الوقت، وإدارات جديدة وحكومات مختلفة ورؤى متباينة تفتح الآفاق أمام ظلٍ جديد من العودة إلى ما قبل القطيعة، وفتح صفحاتٍ جديدة أمام تعاون مُشترَك.
وهذا بعدما أصبحت العلاقات شبه مستحيلة، كما أشرنا في التقارير السابقة عن احتداد العلاقات بين نظام الثورة، والملك الحسن الثاني في المغرب.
وقد زاد من تعقيد الأمور إعلان الملك الحسن الثاني، عام 1982، “تكفيـر” الخُميني؛ بُناءً على فتوى استصدرها من فقهاء مغاربة. بل أنه عندما شهدت مدن المغرب تظاهرات واحتجاجاتٍ دامية بسبب زيادة أسعار مواد استهلاكية، مطلع عام 1984، قام التلفزيون المغربي ببث خطابٍ آنذاك للملك الحسن، اتهم فيه إيران بالتحريض على الاحتجاجات في بلاده، وذكر في معرض حديثه أن الخميني كافر مجددًا.
وقد لعب الحسن على وتر النعرة المذهبية، فقد لعبت الاعتبارات الدينية الممُمثَّلة في سُنية المغرب، وشيعية الجمهورية الإيرانية عقب عام 1979، دورًا بارزًا في تشكيل مسارٍ متأزِم بين البلدين، وسنذكر هذا مستقبلًا حول ماهيّة تشكيل الخطاب الديني بابًا من أبواب النزاع والقطيعة بين المغرب وإيران، نظرًا لما يُمثِّله كُل من الحسن الثاني، والمرشد الخُميني، من سُلطاتٍ دينية في بلديهما، واللذان يتقلدان أمير المؤمنين، وأعلى سُلَّم الملالي وآيات الله على الإطلاق، على الترتيب في البلدين.
ولكن يهل عام 1991، على منعطفٍ هام في مسار العلاقات الثنائية، بحيث دخلت الدولتان في مرحلةٍ جديدة من الانفتاح بفعل مجموعة من العوامل الدولية و الإقليمية والمحلية، مثل انهيار المعسكر الشرقي، وانتهاء الحرب الباردة، واللتان قد خلفتا تداعياتٍ واضحة على المصالح القومية الإيرانية دفعتها إلى إعادة ترتيب أولوياتها من جديد سواء في منطقة الشرق الأوسط، أوالعالم العربي و الإسلامي عمومًا، كما أكدت دراسة المركز العربي.
بُعيد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية المدمرة، صعد التيار الإصلاحي على وجه السياسة الإيرانية وأخذ يتقلد المناصب التنفيذية والتشريعية في الجمهورية المحافظية، وأثاروا حالة من النقاش في أوساط القيادات السياسية، والنخب الإيرانية، يتمحور حول اتجاهين أساسين: اتجاه يذهب إلى القول بأن على إيران أن تقدم تجربةً إسلاميةً ناجحة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهوما يتطلب انصرافها للاهتمام بقضاياها.
واتجاه آخر لا يرفض بناء”نموذج ناجح”، ولكنه لا يريد التخلي عن شعارات الثورة، وعلى دور إيران الثوري في العالم، والذي ورثوه عن أبيهم الخُميني، وسيتم التعبير عن هذين الاتجاهين لاحقًا خلال تياري الإصلاحيين والمحافظين.
ولكن دراسة د.عبد العلي السعدي، أشارت إلى أن ظهور خريطة سياسية جديدة والتي كانت أبرز معالمها هي ظهور تعددية سياسية حقيقية على حساب التقاطب الثنائي بين المحافظين والإصلاحيين، عتدما انفرط عقد الإصلاحيين كما انفرط عقد المحافظين إلى أحزاب وقوى سياسية لها رؤاها وبرامجها المميزة، قد قلب الرؤية الثانية سالفة الذكر رأسًا على عقب.
نستطيع أن نقول أن الإصلاحيين دفقوا إلى جسد الدبلوماسية الإيرانية ماء الحياة ليُقيِموه مرةً أُخرى، بعدما أنشئوا حالةً سياسية داخلية صخبة وبها من الزخم ما يُحرِك هذه المياه الراكدة، وتجاوزت الدبلوماسية الإيرانية آنذاك كافة المعوقات الداخلية التي من الممكن أن تؤثر عليها في المحافل الدولية، مثل النقاش الداخلي المُحتدِم آنذاك حول نظام ولاية الفقيه.
واستغل الإصلاحيون ممثلين في هاشمي رفسنجاني، ومحمد خاتمي، اللذين حكما الجمهورية الإيرانية من 1989-1997، و1997-2005 على الترتيب، حرب الخليج الثانية وتداعياتها في إنشاء شكلٍ وهيكلٍ دبلوماسيٍّ بناء للجمهورية، وتخفيف مقولة “التهديد الإيراني” في نظر دول الجوار الإقليمي، واتباع سياسة الانفتاح نحو دول الجوار، في تعزيز العلاقات الإيرانية العربية والإسلامية.
وقد كانت العلاقات المغربية الإيرانية واحدةً من الملفات المُفتَّحة، والتي أقبلت عليها إيران بنيّة الإصلاح، فشهدت العلاقات بينهما مزيدًا من الانفتاح السياسي، وتغير الموقف الإيراني من ملف البوليساريو بالكُلية، فقد جمدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعترافها بحركة البوليساريو، بل ودعمت موقفها هذا من خلال قرارات الأمم المتحدة، مقابل التحصُل على إقرار من المغرب فيما بعد بحق إيران في استعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وقد شهد ديسمبر 1991، الرئيس الإيراني الإصلاحي الأسبق، هاشمي رفسنجاني، يستقبل رئيس الوزراء المغربي آنذاك، على هامش القمة الإسلامية في العاصمة السنغالية، داكار، ويتم الإعلان لاحقًا عن استئناف العلاقات بين الرباط وطهران وشهدت العلاقات مستوى أفضل وتبادل الجانبان الوفود، وفد رُفِع مستوى التمثيل الدبلوماسي عام 1993، إلى مستوى السفراء بعدما كان موقوفًا على مستوى القائمين بالأعمال.
قطيعةٌ إفريقية ولياذٌ بالمغرب
كان الانفتاح الإيرانيّ على المغرب، تتحكم فيه أدوات وضوابط جديدة أساسها منطقة المغرب العربي، وقد فعّلت إيران مع المغرب محورًا ثُنائيًّا، وكان هذا نجدةً لإيران لحفظ ما تبقى من دورها في منطقة المغرب العربي.
ولكن لماذا؟
حدثت قطيعة دبلوماسية بين إيران والجزائر عام 1993، عقب اتهاماتٍ مُوجَّهة من قِبل السلطات الجزائرية لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية عقب اندلاع المواجهات المسلحة بين الدولة والحركات الإسلامية المسلحة، لاسيما وأن الجزائر كانت تملك يقينًا من دعم إيران للجماعات التي تُجابِهها، وهذا بعدما كانت تُمثِّله الجزائر لإيران كنقطة ارتكاز أساسية للحضور الإيراني في منطقة المغرب العربي، والحليف المفضل لطهران، بفعل تقاسم القيم الثورية بين البلدين. كما أفادت الدراسة.
جفاء دبلوماسي آنذاك حاكم لمسار العلاقات الليبية الإيرانية، وذلك منذ واقعة اختفاء الإمام “موسى الصدر”، في الحادي والثلاثين من أغسطس / آب لعام 1978، واصبح الإيرانيون في حالةٍ من الإصرار على إظهار ومعرفة الحقيقة في هذه القضية.
وموسي الصدر، شخصية دينية لبنانية شيعية بارزة، كما أنه مؤسس حركة أمل، وكان قد وصل إلى ليبيا في زيارةٍ للمشاركة في احتفالات “ثورة الفاتح من سبتمبر”، التي أوصلت القذافي إلى السلطة عام 1969، وكان بصُحبة الشيخ، محمد يعقوب، والصحفي، عباس بدر الدين، وتمت استضافتهم في فندق الشاطئ بطرابلس، وشُوهِد الصدر ورفيقاه لآخر مرة في 31 أغسطس/آب 1978.
وقد أعلنت السلطات الليبية حينها أن الصدر ورفيقيه غادروا طرابلس مساء 31 أغسطس/آب على متن رحلة للخطوط الإيطالية متوجهة إلى روما، وعثُرت السلطات الإيطالية فيما بعد على حقائب الصدر والشيخ يعقوب في فندق “هوليداي إن” بروما.
وقد انتهت تحقيقات القضاء الإيطالي إلى قرار من المدعي العام في روما عام 1979، بحفظ القضية بعد أن تأكد أن الصدر ورفيقيه لم يدخلوا إلى الأراضي الإيطالية.
أزمةٌ حادة أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيران، وكانت الأزمة على خلفية اتهام نظام الرئيس التونسي الأسبق،الحبيب بورقيبة (1987-1957)، لإيران بدعم قوى دينية شيعية في البلاد، وطفت على السطح المخاوف التونسية من تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية.
في وسط هذا المناخ من القطيعة والجفاء، بدأت تظهر بعض التعديلات على السياسة الخارجية الإيرانية، والإيمان بأن المغرب هو المُتنفَس الجديد القديم لإيران في منطقة المغرب العربي، لا سيما مع تفوق جناح الإصلاحي “هاشمي رافسنجاني” على جناح الراديكاليين المتشددين، وهو ما أتاح فرصة تقييم الموقف الإيراني من الأوضاع في المغرب العربي ومراجعة التأييد الواضح الذي كانت تظهره طهران للحركات الإسلامية المحلية.
ومن ثمَّ فقد سعى الإيرانيون إلى توسيع العلاقات الدبلوماسية العادية مع دول المغرب العربي إلى علاقات أكثر تقدمًا، بعدما تعرضت علاقاتهم مع دول المشرق العربي إلى أزماتٍ دبلوماسية لم تعرف معنى الحل حتى هذه اللحظة.
كُلِّلت مساع رفسنجاني بالنجاح، ولكن قطف ثمارها خلفه الإصلاحي، محمد خاتمي، وأصبح الصعيد السياسي بين إيران والمغرب يشهد تصاعدًا وحراكًا قويين، عكسته الزيارات المتبادلة، على مستوٍ عالٍ، ابتداءً من زيارة وزير الخارجية الإيراني الأسبق، علي أكبر ولايتي، عام 1997، وبعده الزيارة الرسمية الشهيرة التي قام بها الوزير الأول المغربي السابق، عبد الرحمن اليوسفي، في عام 2001، إلى إيران.
وبدا أن محمد خاتمي، ومحمد السادس يريدان طوي صفحة أسلافهم في القطيعة والجفاء، كما أرسى الملك محمد السادس مقاربةً جديدة لتنويع العلاقات الدولية للمغرب، وقد أسفرت هذه الزيارات عن توقيع المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وبعده زيارة وزير الخارجية الإيراني السابق، كمال خرازي، عام 2004، وزيارة وزير الخارجية السابق، منوشهر متكي، في عام 2007، وتوقيعه مع نظيره المغربي على مذكرة تفاهم تشمل إقامة آليات للمشاورة السياسية بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية.
وفي هذه الفترة تناثرت الاتفاقيات التعاونية في مجالات السياسة والاقتصاد وحُقول أخرى، حتى لا يكاد يُعلَم عددها، وقد شُيِّدت إمبراطورية من الوشائج والأواصر، يكاد الناظر لا يضع في خلچه أنها من المتوقَع ستنهار يومًا ما، ولكن الواقع يقول أنها قد انهارت، وحدث ذلك عام 2009.
ففيما يا تُرى سقط الُبنيان؟، #هذا ما سنستعرضه الجزء القادم.