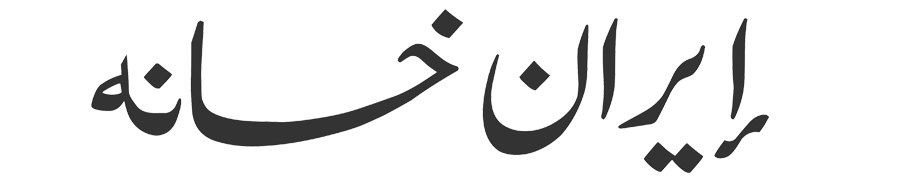لا يمكن لتجربة مشاهدة فيلم “تاكسي طهران” للمخرج الإيراني جعفر بناهي أن تكون خالصة لوجه المتعة السينمائية، فالظروف المُحيطة بصنع الفيلم حتمًا ستلقي بظلالها الثقيلة على المتفرج.
جعفر بناهي هو مخرج إيراني شهير، فنان سينما سُجن ومُنع من صنع الأفلام بإرادة سياسية، لكنه ما زال يتحدى تلك الإرادة بتصوير الأفلام سرًا وتهريبها للعرض في الخارج.
وفي هذا الفيلم الأخير على قائمة أعماله، يلجأ بناهي إلى حيلة ذكية على بساطتها لصنع فيلمه، ينتقل عبرها من مقعد المخرج السينمائي إلى مقعد سائق التاكسي، الذي يتتالي على سيارته الركاب من مختلف المهن والطبقات، ركاب هم دائمًا في عجلة من أمرهم، يتنقلون عبر تاكسيه مُحمّلين بمشاكلهم وخلفياتهم الاجتماعية، وفي مشوار التاكسي – تلك الاستراحة القصيرة إن جاز التعبير – تسنح الفرصة لبناهي كي يعرض حكايات شخصياته. وتتضافر تلك الحكايات الصغيرة، كقطع من الموزاييك، لتصنع لوحة واقعية للمجتمع الإيراني.
إن بناهي في فيلمه هذا هو سائق تاكسي بدون رخصة قيادة، يصنع فيلمًا بدون ترخيص بالتصوير.
في مشهد من مشاهد الفيلم الدالة، يقوم السائق جعفر بناهي بتوصيل طفلة، هي هناء سعيدي ابنة شقيق جعفر نفسه، بعد انتهاء دوامها الدراسي. تطلب منه الطفلة نصيحة بخصوص واجب مدرسي كلفتهم به المعلمة وهو: صنع فيلم. وتعدد له الطفلة القواعد التي أملتها عليهم المعلمة لمراعاتها أثناء تصوير أفلامهم. لائحة ممنوعات طويلة مثل: احترام الحجاب والزي الإسلامي المحتشم، عدم تصوير مشاهد يحدث فيها تلامس بين رجل وامرأة، استخدام أسماء اسلامية للشخصيات (ويُفضل استخدام أسماء الأنبياء)، وبالطبع عدم نقاش المواضيع السياسية أو الإقتصادية.
يلخص هذا المشهد الأزمة التي يعيشها أي مخرج سينمائي إيراني، كيف يمكن له أن يصنع فيلم دون المساس بالمحرمات الرقابية في بلده؟ معادلة صعبة يضطر فناني السينما الإيرانية إلى التعامل معها بالدوران حول قائمة المحرمات في أفلامهم. صحيح أن كثير منهم استطاع رغم هذه الضوابط الثقيلة صنع أفلام حققت نجاحًا عند جمهور السينما في العالم وتم تقديرها بشكل واسع في المهرجانات الفنية الدولية، لكنها بالضرورة تحد كثيرًا من حرية الفنان في اختيار مادة موضوعه وطريقة معالجته.
في فيلمه يلتزم بناهي بدرجة كبيرة بهذه المحظورات، فلا نرى ظهورًا لشعر ممثلة أو تلامسًا بين رجل وامرأة، لكنه لا يستطيع مقاومة عدم نقاش موضوع القمع في مشهد أو اثنين في فيلمه، بل أننا يمكن أن نقول أن الفيلم برمته – حتى ولو لم يناقش السياسة – يمثل وثيقة ادانة لقمع الفنان.
ربما لم يستطع بناهي – الممنوع من مغادرة إيران – أن يحضر عروض أفلامه في مهرجانات العالم، أو أن يتسلم جائزة الدب الفضي التي فاز بها فيلمه في مهرجان برلين – والتي تسلمتها عنه الطفلة الصغيرة هناء سعيدي – لكنه بالتأكيد استطاع إيصال صوته بوضوح.
في البداية أراد بناهي لفيلمه أن يكون وثائقيًا بالكامل؛ كاميرات موضوعة في أركان التاكسي تلتقط ما تجود به الصدفة في شوارع طهران، لولا أن أحد الركاب اعترض على تصويره رغم إرادته. بسبب اعتراض الراكب تخلى بناهي عن طموحه الوثائقي هذا، واستبدل الركاب الحقيقيين بممثلين مغمورين يمكنه أن يعرض من خلالهم مشاكل مجتمعه. وعبر صيغة سردية تجمع المشاهد المُعدة سلفًا بارتجالات الممثلين، صنع بناهي فيلمه.
رغم قلة خبرة طاقم التمثيل الذي استخدمه بناهي في فيلمه، إلا أنه استطاع أن ينتزع منهم أداءً جيدًا إلى حد كبير، بل يحصل إلى درجة التميز كما في دور بائع الاسطوانات المدمجة القزم، والذي استطاع ممثله – مجهول الاسم بالنسبة للمُشاهد – رغم قصر مدة ظهور دوره أن يقدم أداءً شديد الظرف والطبيعية. أما بناهي نفسه فقد قدم أداءًا تمثيليًا بسيطًا لا يعدو كونه مرآة يتتابع عليها ظهور شخصياته.
نجح أيضًا بناهي في نقل الإحساس بالزمن الواقعي على الشاشة دون أن يقع في الملل، بل على العكس تميز الفيلم بحيوية كبيرة في معظمه رغم ثبات الكاميرات ومحدودية موقع التصوير بحدود التاكسي، بسبب سرعة تتالي الشخصيات والحكايات على مشاهد الفيلم. صحيح أن ايقاع الفيلم قد تباطئ قليلًا في ثلثه الأخير، إلا أن حضور الطفلة المرح في تلك المشاهد خفف كثيرًا من الشعور بالملل.
كان أكبر عيوب الفيلم بحق في تلك اللحظة التي اختارها بناهي لإنهاء الفيلم، إذ جاءت غير موفقة ومبتسرة بدرجة كبيرة، بالذات لأن الشكل الذي اختاره لفيلمه كان يسمح بظهور شخصيات وحكايات أكثر بكثير. وبدلًا من أن يحاول الفيلم نسج حبكة ومتابعتها للنهاية، اكتفى بصنع كولاج سينمائي بروح تسجيلية لا يصل أبدًا لذروته الدرامية.
رغم هذا يظل الفيلم ممتعًا إلى حد كبير، ووثيقة سينمائية رفيعة على قدرة الفنان على تحدي كل الظروف والخروج بفنه إلى العالم. وربما شعر جمهور السينما ببعض الاحباط من الفيلم، ذلك لأنهم كانوا ينتظرون ما هو أكبر من مخرج بحجم جعفر بناهي، ولكن في النهاية من يستطع أن يلومه. إن المُشاهد لا يملك في النهاية سوى الاعجاب بإرادة وقدرة بناهي الاستثنائية على الإستمرار في صنع الأفلام، رغم القمع والتضييق.